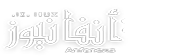لم يعد الحديث عن أزمة المياه في المغرب مجرد تخوفات أو سيناريوهات مستقبلية، بل أصبح واقعا ملموسا يعكس هشاشة المنظومة المائية الوطنية أمام التحولات المناخية والضغوط البشرية. فمنذ ستينيات القرن الماضي، كان نصيب الفرد من المياه العذبة يفوق 2500 متر مكعب سنويا، أما اليوم فقد تراجع إلى أقل من 620 متر مكعب، وهو مستوى يضع المملكة ضمن خانة “الإجهاد المائي الحاد” حسب مؤشرات البنك الدولي.
السدود التي شكلت لعقود القلب النابض للأمن المائي والزراعي لم تعد قادرة على أداء دورها بنفس الفعالية، إذ لا يتجاوز معدل ملئها حاليا 34 في المئة، فيما تهاوت بعض السدود الاستراتيجية إلى ما دون 10 في المئة. أما الموارد الجوفية، فقد نالها الاستنزاف المفرط والتلوث، مما يهدد ليس فقط الإنتاج الفلاحي، بل حتى التزود بالماء الصالح للشرب والصحة العامة لشرائح واسعة من المواطنين. هذا التدهور قد يفتح الباب أمام موجات نزوح داخلي نحو المدن الكبرى، بما يحمله ذلك من توترات اجتماعية واقتصادية إضافية.
المغرب أمام عطش القرن: كيف يواجه خطر الانهيار المائي؟
في مواجهة هذا الوضع المركب، ترتفع أصوات الخبراء المطالبين بتعبئة شاملة تتجاوز الحلول الظرفية نحو رؤية استراتيجية مستدامة. ومن أبرز المقترحات المطروحة توسيع مشاريع تحلية مياه البحر على طول السواحل، وربط الأحواض المائية ببعضها لتخفيف الضغط عن المناطق الأكثر عطشا، إلى جانب إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها في القطاعين الزراعي والصناعي. كما يُعتبر تعميم أساليب السقي المقتصدة للماء، خاصة في الزراعة المسقية، خيارا أساسيا لا يحتمل التأجيل.
غير أن البنية التحتية وحدها لا تكفي، إذ تظل مسألة ترشيد الاستهلاك اليومي داخل المدن والقرى عاملا حاسما. هنا تبرز الحاجة إلى حملات توعوية شاملة، ترافقها قوانين صارمة تحد من حفر الآبار العشوائية وتحمي الفرشات المائية من الانهيار. كما يطرح العديد من المتخصصين أهمية إدراج ثقافة الحفاظ على الماء في المناهج التعليمية منذ المراحل الأولى، لخلق وعي جماعي بأن الماء ثروة وطنية نادرة وليست موردا بلا نهاية.
وتؤكد الخبيرة في الهندسة البيئية والهيدروليك، أميمة خليل الفَن، أن الأزمة الحالية ليست مجرد ظرفية مرتبطة بتوالي سنوات الجفاف، بل هي انعكاس مباشر لتقاطع تغير المناخ مع الضغط الديمغرافي وضعف البنية التدبيرية. وتضيف أن “الأمن المائي لم يعد مسألة تقنية فقط، بل قضية سيادية تتطلب انسجام السياسات العمومية مع الابتكار التكنولوجي والوعي المجتمعي.”
أمام هذا الواقع، يبدو واضحا أن الحفاظ على الموارد المائية لم يعد ترفا أو خيارا سياسيا قابلا للأخذ والرد، بل ضرورة وجودية ترتبط بمستقبل المغرب برمته. فإذا كان القرن الماضي قد شهد بناء السدود كحل استراتيجي، فإن القرن الحالي يفرض التفكير في حلول أكثر شمولية وجرأة، قادرة على إنقاذ البلاد من عطش يلوح في الأفق القريب.