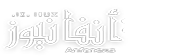في زمن تتسارع فيه أعمار المجتمعات وتطول فيه متوسطات الحياة، يطل علينا مصطلحان يبدوان وكأنهما توأمان: الخرف والألزهايمر. كثيرون يستخدمونهما بالتبادل، كما لو كانا مرضا واحدا يحمل اسمين مختلفين. لكن الحقيقة الطبية أعمق بكثير، والخلط بينهما قد يحجب فهما دقيقا لطبيعة المعاناة التي يعيشها ملايين حول العالم.
الخرف ليس مرضا، بل مظلة واسعة تضم مجموعة من الأعراض التي تضعف القدرة على العيش باستقلالية. ذاكرة تتبخر تفاصيلها القريبة، تركيز يذوب في ازدحام اللحظة، قرارات تصبح أثقل من الجبال، كلمات تضيع قبل أن تكتمل جملة، وشخصيات تنقلب رأساً على عقب.. كلها إشارات تدل على أن الدماغ يرسل نداء استغاثة.
أما الألزهايمر، فهو قصة أخرى: مرض دماغي تنكسي محدد، العدو الأكثر شراسة داخل هذه المظلة، المسؤول عن ما يقارب 60 إلى 80 في المائة من حالات الخرف. يبدأ خلسة من المناطق المسؤولة عن التعلم، فيسرق القدرة على تذكر الجديد، ثم يتوسع ليشوش الزمن والمكان، ويبدل السلوك واللغة، إلى أن يجرد المصاب من أبسط وظائفه الحيوية كالمشي والبلع والكلام.
لكن الخرف ليس حكرا على الألزهايمر. هناك وجوه أخرى للمعاناة: الخرف الوعائي الناتج عن الجلطات الدماغية، الخرف الجبهي الصدغي الذي يضرب مركز السلوك والشخصية، أو خرف أجسام ليوي الذي يحمل أعراضاً شبيهة بالباركنسون، وحتى الخرف المختلط الذي يجمع أكثر من خلل في دماغ واحد.
الصدمة تكمن في أن الخرف ليس “طبيعيا” في الشيخوخة. إنه دليل على تلف عصبي يعطل شبكة الخلايا الدماغية. والأدهى أن الألزهايمر قد يزور شباناً لم يتجاوزوا الخامسة والستين، حيث تشير التقديرات في الولايات المتحدة وحدها إلى إصابة نحو 200 ألف شخص بما يعرف بـ”الألزهايمر المبكر”.
إدراك الفارق بين “الخرف” و”الألزهايمر” ليس ترفا لغويا ولا تمييزا أكاديميا؛ إنه وعي ضروري يغير طريقة تعامل الأسر ومقدمي الرعاية مع المريض. حين نفهم أن كل عرض له سببه ومساره، نصبح أكثر قدرة على بناء خطط واقعية لدعم المصاب، وإضاءة شمعة في نفق طويل اسمه فقدان الذاكرة.